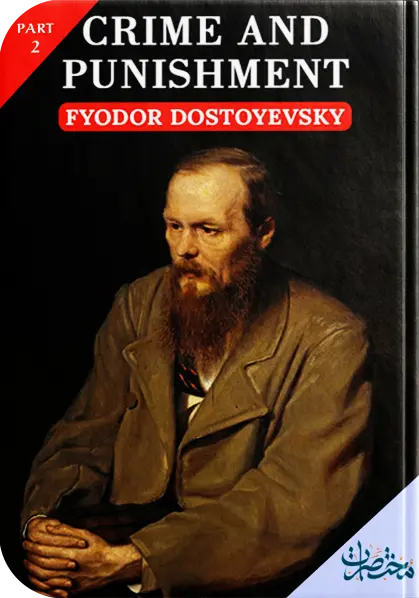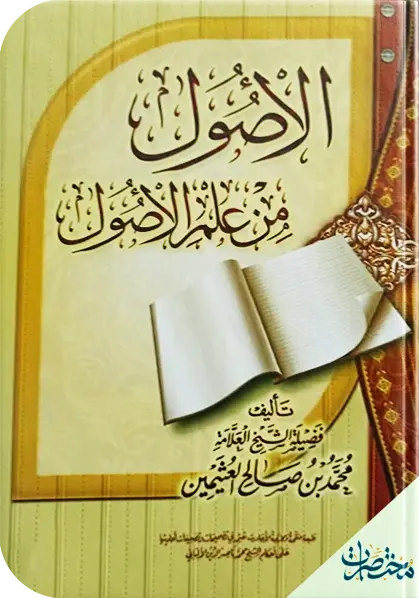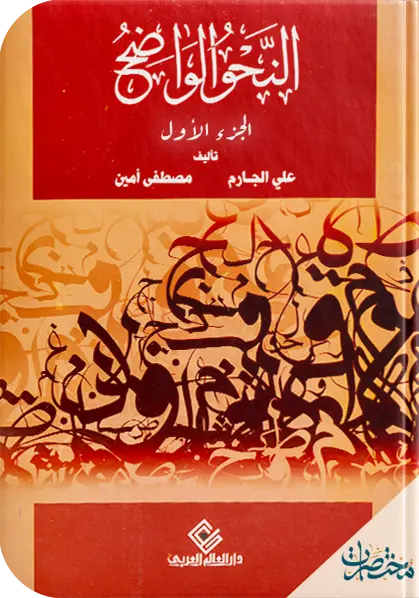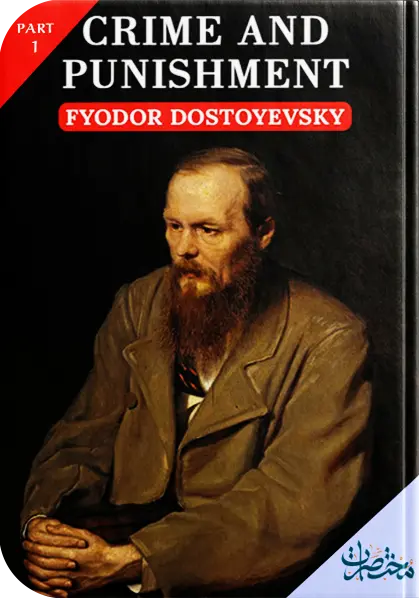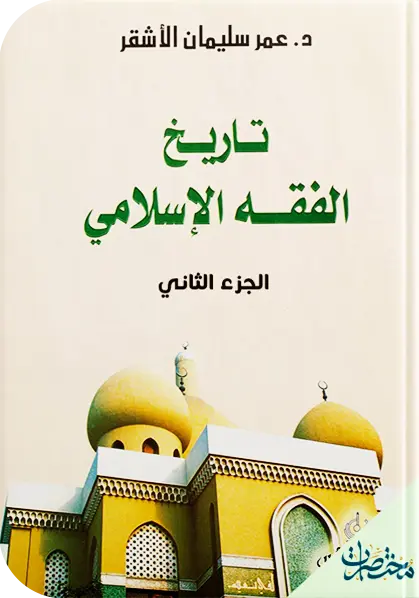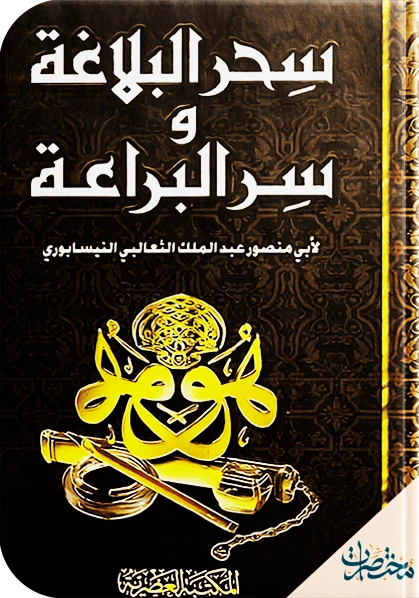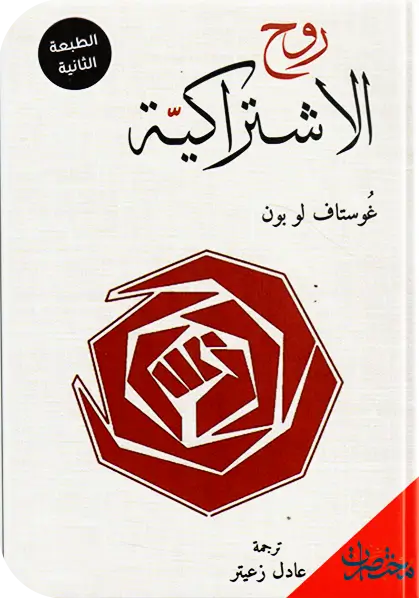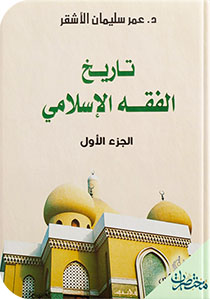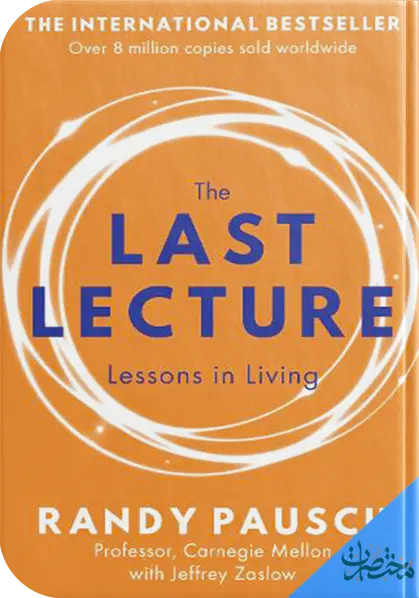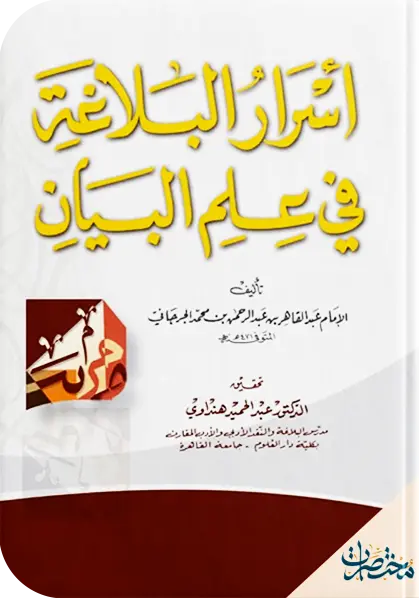
قيم هذا الكتاب
أسرار البلاغة
هل ترغب في فهم أسرار الجمال اللغوي وروعة التعبير في اللغة العربية؟
كتاب "أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني يأخذك في رحلة عميقة داخل عالم البلاغة، حيث يشرح بمهارة أساليب التعبير الفني في القرآن والشعر العربي.
ستتعلم من خلاله فنون التشبيه، الاستعارة، المجاز، وكيفية استخدام اللغة لتوصيل أعمق المعاني بأبسط
الأفكار الرئيسية للكتاب
- نظرية النظم: الجمال البلاغي يكمن في أسلوب بناء الجملة، وليس في اللفظ أو المعنى منفردًا.
- التقسيمات البلاغية: توضيح الفروق بين الاستعارة، التشبيه، والتمثيل.
- دور البلاغة في اللغة: إبراز أهمية التجنيس، الحذف، والزيادة في بناء الكلام.
- التأصيل لعلم البلاغة: الكتاب يعتبر مرجعًا تأسيسيًا لعلم البيان والمعاني.
ماذا تجد في الكتاب؟
- تأسيسًا منهجيًا لقواعد البلاغة العربية بأسلوب دقيق ومفصل.
- شرحًا معمقًا لمفاهيم الحقيقة والمجاز، الاستعارة، التشبيه، والنظم في البلاغة.
- تحليلاً بلاغياً مدعماً بالأمثلة من القرآن الكريم، الحديث الشريف، وشعر العرب.
مُختصر المُختصر
-
منزلة الكلام:
- يبدأ الكتاب بتوضيح أهمية الكلام كميزة أساسية للإنسان تميزّه عن الحيوانات.
- يناقش الفروق بين اللفظ والمعنى وكيفية تأثيرهما في بلاغة الكلام.
-
التجنيس والحشو:
- يستعرض الجرجاني مواضع الاستحسان في استخدام اللفظ، مثل التجنيس والحشو.
- يقدّم تفصيلًا دقيقًا لأنواع التجنيس المستحسنة، ويُبرز كيفية تحقيق الجمال البلاغي من خلالهما.
-
الاستعارة:
- يعرّف الاستعارة ويستعرض أقسامها المختلفة.
- يشرح الخصائص المفيدة للاستعارة ويُبين الفرق بينها وبين التمثيل، مع توضيح كيفية تأثيرها في البلاغة.
-
التشبيه:
- يُوضّح الجرجاني أقسام التشبيه وكيفية استخدامه في تحسين البلاغة.
- يقارن بين التشبيه والتمثيل، ويشرح مفهوم التشبيه المتعدد والمركب، مع تبيين الفرق بينهما.
-
الأخذ والسرقة:
- يتناول مسألة الأخذ والسرقة في سياق البلاغة.
- يشرح التعليل المتعلق بالأخذ والسرقة، ويبحث في ضروب الحقيقة والتخييل.
-
المجاز:
- يعرّف المجاز ويستعرض معناه وحقيقته.
- يُميز بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي، ويشرح الفرق بينهما وتأثيرهما في البلاغة.
-
الحذف والزيادة:
- يناقش دلالة الحذف والزيادة في البلاغة.
- يبحث في ما إذا كان الحذف والزيادة يُعتبران من المجاز أو لا، وكيفية تأثيرهما على فهم النصوص البلاغية.
الإقتباسات
“اعلم أنَّ الكلام هو الذي يُعطي العلومَ منازلها، ويبيّن مراتبها، ويكشفُ عن صُوَرها، ويجني صنوفَ ثَمَرها، ويدلُّ على سرائرها، ويُبْرِزُ مكنون ضمائرها، وبه أبان الله تعالى الإنسان من سائر الحيوان، ونبّه فيه على عِظَم الامتنان“
“ صارت الألفاظ لذلك كالماء الذي يسوغ في الحلق والنسيم الذي يسري في البدن ويتخلل المسالك اللطيفه منه، ويهدي إلى القلب روحًا ويوجب في الصدر انشراحًا ويفيد النفس نشاطًا، وكالعسل الذي يلذ طعمه وتهش النفس له.“
“ حينما تقول: رأيت أسدًا، تُريد رجلاً شبيهاً به في الشجاعة، وظبيةً، تريد امرأة شبيهة بالظبية، فالتشبيه ليس هو الاستعارة ولكن الاستعارة كانت من أجل التشبيه، وهو كالغرض فيها، وكالعلّة والسبب في فِعْلها.“
“ المجاز مَفْعَلٌ من جازَ الشيءَ يَجُوزه، إذا تعدَّاه، وإذا عُدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة، وُصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعَه الأصليَّ، أو جاز هو مكانه الذي وُضع فيه أوَّلاً.“
““
قد يعجبك قرائتها ايضا